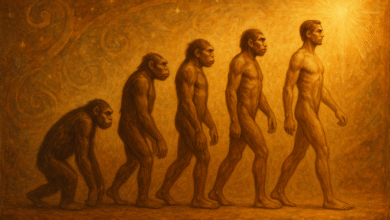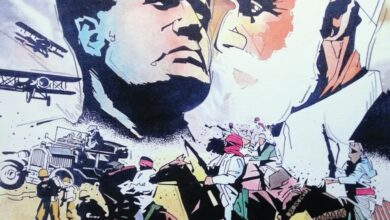حوار مع الناقد المغربي الدكتور حسن مخافي – ناقد وأستاذ جامعي
القصيدة المغربية التطور والمآلات
حاوره: السعيد الخيز – يونس الهديدي
المواكبة التقنية: عبد اللطيف الطالبي
• كيف يقرأ حسن مخافي راهن القصيدة المغربية؟
من الصعب أن أجيب في حَيِّزٍ زمني قصير عن هذا السؤال العريض. فعندما نتحدّث عن الشعر المغربي، فإننا نتحدث عن مسار طويل من التطوّر بدأ مع بداية الستينيات تقريبًا، ومرّ بمراحل عديدة أوصلتنا إلى ما عليه الشعر المغربي اليوم. والمشهد العام للقصيدة المغربية – في اعتقادي – يلفّه الكثير من الغموض والارتباك أيضًا. لماذا؟ لأن اكتشاف قارة قصيدة النثر من طرف الشعر المغربي، الذي بدأ يكتبها فعليًّا منذ بداية الثمانينيات، أتاح الفرصة لمجموعة من الأقلام الشابّة التي استسهلت الكتابة الشعرية نوعًا ما. وقد أدى ذلك إلى نوع من الارتباك في المشهد، إلى الحدّ الذي أصبحنا معه نقرأ كتبًا وُضع على أغلفتها عنوان “شعر”، وهي في الحقيقة ليست من الشعر في شيء.
لكن هذا الارتباك – في تقديري – ارتباك مؤقت. لماذا؟ لأنّه في النهاية لا يصحّ إلا الصحيح. والزمن كفيل بغربلة هذا التراكم الكمي الكبير من الإصدارات الشعرية أو ممّا يدّعي أنه شعر. وستؤدي هذه الغربلة الحتمية إلى ظهور الشعر الحقيقي. وأعتقد أنّ هذه الظاهرة في النهاية صحية، لأنّ جميع المجتمعات مرّت بها، في العالم العربي وخارجه.
• هل يمكن الحديث عن أرضية انبثقت منها القصيدة المغربية الحديثة؟
مع بداية الستينيات، ظهرت القصيدة المغربية الحديثة بمعنى الانتماء إلى الحداثة، لا بالمعنى الزمني لكلمة “حديثة”، بل بمفهوم الانتساب إلى روح الحداثة. وقد قادت هذه التجربة نخبة من الشعراء، كل واحد منهم ينتمي إلى اتجاه خاص به. فالقصيدة المغربية لم تنطلق من رؤية واحدة، بل وُلدت من رؤى شعرية متعددة. فإذا قارنّا بين روادها الأوائل – محمد السرغيني، وعبد الكريم الطبال، وأحمد المجاطي – وجدنا أنّ كل واحد منهم انطلق من رؤية شعرية مغايرة.
• على أساس هذا التنوع في النشأة، هل يمكن الحديث عن روافد متعددة للتجربة الشعرية المغربية الحديثة، لا سيما منها الرافدان المشرقي والأوروبي؟
نعم، لقد ظهرت القصيدة المغربية الحديثة منذ البداية متنوّعة، وهذا منحها غنىً واضحًا على مستوى اللغة والتجربة والرؤية. فإذا أخذنا مثالًا: محمد السرغيني وأحمد المجاطي، نلاحظ أنّ السرغيني تأثر كثيرًا بالمدرسة التشكيلية في العراق، إذ درس هناك في الخمسينيات وعايش عن قرب تجربة الحداثة الشعرية، لكنه لم يكن ميّالًا إلى “القصيدة الملتزمة”، بل إلى القصيدة الرؤيوية، على خطى حركة مجلة”شعر” بقيادة أدونيس ويوسف الخال.
أما أحمد المجاطي، الذي درس بدوره في سوريا، فقد ظلّ على تماس مع ما كان يُسمّى آنذاك “شعر المقاومة”، فكان ميّالًا إلى القصيدة الملتزمة، على الرغم من مسحة رومانسية واضحة في بعض نصوصه. لذلك نجده أسبق إلى معالجة الأحداث الجسام التي عرفها المغرب في الستينيات والسبعينيات، وأسبق إلى تخصيص حيّز واسع من شعره للقضية الفلسطينية.
وبالنسبة إلى عبد الكريم الطبال ومحمد الخمار الكنوني، فقد تأثّرا كثيرًا بالشعر الإسباني بحكم انتمائهما إلى شمال المغرب، ما منح قصيدتهما طابعًا مختلفًا عن قصيدة السرغيني أو المجاطي.
إذًا، نستخلص أنّ القصيدة المغربية الحديثة لم تبدأ وفق اتجاه واحد، بل انبثقت من رفض جماعي أو ثورة على القالب التقليدي القائم على الوزن والقافية، غير أنّ هذا الرفض حمل في داخله اتجاهات متعدّدة بتعدّد الشعراء وتجاربهم الخاصة.
• لعلّ هذا يقودنا إلى ما تصفه بالتجاوز، وإلى كوكبة أخرى من شعراء الحداثة المغربية مثل بنطلحة والجواهري والحجام. كيف تقيّم موقع هؤلاء الشعراء؟
ينتمي هؤلاء الشعراء إلى ما يمكن أن نسميه “مرحلة الامتداد وترسيخ الحداثة الشعرية” في القصيدة المغربية. غير أنّ ثمّة ملاحظة قلّما أُثيرت: كان من الممكن أن يكون لكل واحد من هؤلاء الرواد تلاميذ يطوّرون التجربة، غير أنّ الأحداث التي عاشها العالم العربي، إضافةً إلى استمرار تأثير القصيدة المشرقية في الشعر المغربي، جعلت هؤلاء الرواد بلا “ذرية شعرية”. لذلك، ومع أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، بدأنا نتحدّث عن تجربة جديدة في الشعر المغربي، تجربة وُلدت من رحم التأثر العميق بهزيمة 1967، التي تركت أثرًا بالغًا في الثقافة العربية عمومًا، وفي الشعر العربي خصوصًا.
• أين تكمن ريادة هؤلاء الشعراء الجدد؟
تكمن ريادتهم أوّلًا في تفاعلهم مع الأحداث الاجتماعية والسياسية في المغرب والعالم العربي. وقد أدى ذلك إلى بروز ما عُرف بـ “القصيدة الملتزمة”. وهي قصيدة تبشيرية ركزت على الوضوح وعلى اللغة المباشرة، مع المحافظة على الوزن والقافية ضمن إطار قصيدة التفعيلة. وقد هيمنت هذه القصيدة على المشهد الشعري المغربي في تلك المرحلة، من دون أن تمنع بعض الشعراء من كتابة نصوص رومانسية وذاتية، كما نجد في قصائد عبد الرفيع الجواهري، وخاصة في ديوانه “القمر الأحمر”.
• هل تضع محمد بنطلحة في موقع خاص ضمن هذه الكوكبة؟
بالتأكيد. محمد بنطلحة شاعر ذو تجربة عميقة امتدّت لأكثر من نصف قرن، وحقّق خلالها تراكمًا كمّيًا ونوعيًا لافتًا. لم يكن شاعرًا “تجريبيًا” بالمعنى الضيّق، بل ظلّ مخلصًا للأسس الكبرى التي تصون جوهر الشعرية: اللغة، والخيال الواسع، والإيقاع. وقد نظم قصائد موزونة ومقفّاة تندرج في فضاء قصيدته الحرة، ما منحه مكانة مرموقة في الشعر المغربي، بدواوينه العديدة التي صدرت على مدى أربعة عقود.
• هل كان لدى الشعراء المغاربة هاجس تأسيس قصيدة مغربية محلية، لا تذوب في الحداثة المشرقية ولا في التجربة الغربية؟
نعم، كان هذا الهاجس حاضرًا منذ البدايات. عند محمد الصباغ مثلًا، نجد خصوصية تنبع من المكان، كمدينة فاس بتراثها وأعلامها. غير أنّ الخصوصية بالمعنى الشعري الأعمق لم تتبلور إلا في أواسط السبعينيات، حين استنفدت القصيدة الملتزمة طاقتها ودخلت في أزمة كتابة. هذا دفع بعض الشعراء مثل علي الهواري إلى التوقف عن الكتابة، فيما اتجه آخرون إلى تجربة جديدة هي تجربة “الكاليغرافيا”، التي قادها محمد بنيس وعبد الله راجع وغيرهما.
• وهل كان الأفق الجديد الذي انفتح بعد تجربة الكاليغرافيا هو قصيدة النثر؟
نعم. ففي مطلع الثمانينيات برزت قصيدة النثر المغربية. وعلى الرغم من أنّ ملامحها الأولى نجدها عند محمد الصباغ، فإن انطلاقتها الحقيقية كانت مع محمد بنيس في قصيدته “الواقعة” المنشورة في مجلة “الكلمة”. ومن هنا وُلد جيل جديد من الشعراء هو جيل الثمانينيات، الذي تميّز بتحرّره من الأيديولوجيا، وانفتاحه على ثقافات متعددة (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية). وقد منح هذا الانفتاح القصيدة المغربية ثراءً خاصًا، وجعلها أكثر تمرّدًا على الأشكال القديمة.
• كانت الثمانينيات فترة صعبة سياسيًا. كيف انعكس ذلك على الشعر؟
صحيح، لكنها اختلفت عن السبعينيات. فلم يعد الهاجس السياسي هو المحرّك الأساس للشعراء، بل أصبح الهاجس الشعري ذاته. صار الشاعر يعتبر ذاته مصدرًا ومآلًا للتجربة الشعرية. وهكذا وُلدت قصيدة ذات بُعد وجودي، مخلصة للأحاسيس والعوالم الداخلية.
• بعد قصيدة النثر، ومع بروز الثورة الرقمية، ظهرت مسمّيات جديدة مثل “القصيدة الرقمية” و”القصيدة الإلكترونية”. كيف ترونها؟
أتحفّظ على هذا المصطلح. فالشعر الحقيقي مرتبط بالعمق الإنساني، لا بما يكتبه الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي. القدماء تحدثوا عن “ماء الشعر”، وهذه النصوص التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى ذلك الماء.
• وماذا عن شعر الهايكو؟
الهايكو شعر ياباني لصيق باللغة اليابانية، ولا يمكن كتابته بلغة عربية بالجوهر نفسه. لقد اطّلعت على بعض التجارب، خصوصًا عند صديقنا الشاعر سامح درويش الذي أصدر مجموعات عديدة تحت مسمّى “شعر الهايكو”. غير أنّني لا أرى فارقًا واضحًا بينها وبين قصائد النثر الأخرى في المغرب والعالم العربي. لم أفهم بعد ولم أتوصل إلى الأسباب والدوافع التي جعلت هذا النوع من النصوص تُسمّى “هايكو”. ببساطة: الشعر هو اللغة. فهل يستطيع شاعر ياباني أن يكتب قصيدة طللية؟ بالطبع لا، لأنها مرتبطة بخصوصية اللغة والثقافة. كذلك قصيدة الهايكو؛ فهي مرتبطة بالإيقاع والوجود اليابانيين، أي باللغة التي وُلدت فيها. ومن هنا أعتبر محاولات كتابة “هايكو عربي” نوعًا من التجاوز، أو ما يمكن تسميته بـ “المسخ الشعري”.
• وماذا عن قارئ اليوم وعلاقته بالأشكال الشعرية الجديدة؟
بطبيعة الحال، ليس كل قارئ للشعر غارقًا في أدوات التواصل الاجتماعي أو متفرغًا تمامًا للقراءة. ويمكن تقسيم القرّاء إلى قسمين:
- عشاق الشعر: يقرأون بدافع المتعة والفائدة، لا لمكاسب ثقافية أو استثمارية.
- القرّاء بخلفية معرفية: يقرأون بعمق، ويقيمون حوارًا وجدليّةً حقيقية بين النص والقارئ.
• ماذا عن الشعر المغربي بعد سنة 2000؟
مع مطلع الألفية، دخلنا عصر الإنترنت بقوة، وظهرت أسماء جديدة أثْرت المشهد الشعري مثل: محمد الأشعري، فاتحة مرشيد، صلاح الدين بوسريف، وعز الدين بوسريف. كما برزت أشكال شعرية جديدة كقصيدة الهايكو والشعر الإلكتروني. وقد أثّرت وسائل التواصل الاجتماعي في الشعر بوجهين:
- إيجابي: إذ أتاحت نشر الإبداعات الشعرية والوصول إلى جمهور أوسع.
- سلبي: إذ تسيء إلى ذوق القارئ وتسمح بنشر نصوص تُدرج تحت عنوان “شعر”، وهي بعيدة كل البعد عن الشعر.