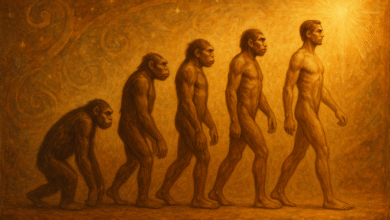“بادشاه” لسعد القرش…
أحلام الفقراء وأوهامه
يوقظ سعد القرش في مجموعته القصصية الصادرة حديثًا عن دار الشروق، وقد حملت عنوان إحدى قصصها “بادشاه”، شخصية مبروك في أولى أجزاء ثلاثيته الروائية “أوّل النهار”. يخال القارئ أنّ الكاتب ندم على موت مبروك في صبيحة يوم عرسه، بعد سقوطه عن سطح العليّة وهو في حالة غبطة وهذيان. عروسه هند في ذلك الصباح المشؤوم، وهبها القرش اسم سنيّة في قصة بادشاه. ومثل هند، حبِلت سنيّة بتوأمين أيضًا، لكن بعد يأس من الإنجاب استمرّ أكثر من عقد. وسنيّة التي عاشت ما يقارب القرن لم يعد بإمكانها إحصاء أحفادها، تتقمّص في القصة شخصية حليمة الأم المؤسّسة – وهي لم تُنجب – في الرواية.
المعادلة الأثيرة عند القرش، الحبّ والموت، تُستعاد هنا أيضًا؛ أو لنَقُل: النجاة بالحبّ، بوصفه هديّة الخلاص. وهكذا تصبح نجاة سنيّة ومبروك من غرق المركب في النيل، وإثمار الخوف من الغرق بمعجزة الحمل، مرآةً مصغّرة ومتعددة الوجوه لنجاة حليمة وعمران من فيضان النيل، وبداية تأسيس قرية “أوزير” المتخيّلة.
ومع “بادشاه” يتذكّر القارئ رواية “المايسترو” ومفارقات المركب الفقير الذي يضم أربعة يتسامرون، يقودهم مصطفى مطلق العنان في الأفكار وضابط إيقاع “الفضفضة”، في مواجهة اليخت العملاق المليء بأسرار الأثرياء. يتكرر المشهد – بصيغة أخرى – في قارب مبروك وسنيّة مقابل مركب المختار، صاحب الجزيرة بأطيانها ومصنعها. غير أنّ المشهد هذه المرة أكثر رحمةً، إذ يقدّم أنموذجًا للمقتدر النبيل، المخلّص اللامرئي، والمنعِم المتعفّف عن طلب الطاعة أو ردّ الجميل.
هذا التضمين السردي في إلحاح بعض المشاهد ليسا تكرارًا عبثيًّا، بل تأكيد للرؤية الناظمة لمشروع سعد القرش السردي، بأسئلته ومساءلاته الجامعة. ومن خلال استلهام الشخصيات والمشاهد في هذا المنجز القصصي الجديد، يوجّه القرش الأسئلة ذاتها في مساحة نصّية أكثر تكثيفًا. لعلّ ثلاث قصص من المجموعة تكفي لتجسيد ذلك، لكنها بلا شكّ لا تغني عن قراءة أخواتها.
“المغيّبون”: ما الذي تراكم في الذاكرة الجمعيّة؟
لنا عودة إلى “بادشاه” بعد تأمل قصة “البحث عن شيطان”، بعنوانها المثير، وبمقدمتها الجاذبة التي تبدأ بمشهد حبّ بين زوجين، كما في سابقتها. فالحبّ هو منطلق الحكي وخلفية الحبكة، وهو أيضًا الواجهة لمغزى القول المضمَر.
الشيخ رمضان، خطيب المصادفة، دخل عالم المنبر ببضعة كتب استلّ منها أخبارًا يبهر بها أبناء قريته “أوزير”، قبل أن يتسلّم الإمامة بدلًا من الشيخ منصور الثرثار، الغائب لأسباب تركها الراوي غامضة. هو رجل فقير نبيه، مترفّع، حاذق في تطييب خاطر زوجته سُكينة، يخفف قهرها ويداويها بالحبّ. في أولى خطبه، اختار أن تكون قصيرة واضحة، تُبعد عن المصلّين الضجر والنعاس، وتخاطب اهتماماتهم مباشرة، بعيدًا من مرويات الصحابة وأساطير الأقدمين. حملت خطبته الأولى عنوان “إتقان العمل”، وتمكّن في بضع خطب، بأسلوب الترغيب فقط، من تقريب الجنّة إليهم، وإحلال الرضى، وإبعاد الظلم؛ فلا خلافات بين النسوة على “قرص جِلّة”، ولا طمع للأخوة في ميراث أخواتهم، ولا تأخير لأجر العامل.
لكن، لماذا شاء الشيخ الطيّب بعد حين أن يبحث عن شيطان يوسوس بين الناس، معتمدًا الترهيب أسلوبًا؟ لقد خشي أن ينفضّ الناس عنه إذا ما اطمأنّوا واهتدوا، وخاف أن يفقد تأثيره حين يقلّ خوفهم من العذاب، فيخسر الهبات والعطايا ويعود إلى الفقر. ولأنه اعتاد الوفرة، أراد أن يبقى “الجسر بينهم وبين الله”. فراح يطيل في سفاسف الأمور، ويزرع بذور الشك في النفوس. تمنّى حدوث الخلافات والظلم كي يظلّ مرجعًا، وبدأ “يبحث عن خطايا وذنوب صغيرة تضمن أن يلجأ إليه الراغبون في التوبة”. في استغلاله للخوف والضعف والجهل، تحوّل إلى تاجر بوعود الغفران، مستحضرًا الشيطان في خطبه، ومناجيًا ربّه:
“إذا صار أهل “أوزير” ملائكة في جنّة الدنيا، فهل يحلمون بجنّتك يا إلهي في الآخرة؟”
الرؤية النقدية هنا جليّة، لا تحتاج إلى إطالة في التفسير.
لكنّ القرش لا يكتفي بنقد من يتولّى رعاية الناس من رجال الدين، كما في شخصية الإمام في قصتنا هذه، بل يورّي نقدًا للرعيّة نفسها وإن لم يبتعد عن السخرية منها في “البحث عن شيطان”. فهو يضعنا أمام لوحتين ساخرتين بطلُهما ما تراكم في نفوس الناس من حبّ التذلّل، وما عشّش في عقولهم من “مهلبية” الأوهام حول جدوى الابتهال المفرط والمديح العمومي في يقين قاطع، وما علق في قلوبهم من خوف من “ذنوب لا يعرفونها”، فيدفعهم ذلك إلى طلب التوبة والمغفرة. وهنا تحديدًا يظهر الناس مطيّة لأصحاب المصالح من ساسة وشيوخ؛ وهذا هو ما يمكن تسميته “الجهل المقدّس”.
غير أنّ الكاتب يرتقي بنا إلى مستوى مختلف في “بادشاه”، إذ يُقابل المختار الإمامَ بصورة نقيضة؛ فهو يتّخذ هيئة المعبود في لا مرئيته، أو يكاد يكون صورة متخيّلة صاغتها أشواق الناس. إنّه الواهب بغير حساب ولا انتظار لردّ الجميل. غير أنّ الناجين من الغرق – بمعنييه الحرفي والرمزي – يظنّون أنّ انقطاعهم للشكر وحده، ومحاصرته بالابتهالات، يسرّه، غير مدركين أن “لا تضيف هذه الطقوس إلى هيبته وعظمته”. في العمق، يُعيد الكاتب طرح المبدأ نفسه: ضرورة الأخذ بالأسباب والعلل، والانصراف إلى الجدّ والعمل، بدل الاكتفاء بكتابة التسابيح وصنع المقارع والمتاجرة بها، أو فتح الأبواب للغرباء الذين يمعنون في تشويه صورة المختار.
المشهد الدرامي النابض بتناقضات النزعات البشرية في “البحث عن شيطان” يتقاطع مع رائعة يوسف إدريس “أكان لا بدّ يا لي لي أن تضيئي النور؟” التي استُلهمت في عمل سينمائي. الضعف الإنساني ذاته نجده عند الشيخين رمضان وعبد العال، وكذلك التحوّل الذي أصابهما، والانقلاب على الذات، وإن اختلفت الوجهتان. عبد العال انهزم أمام جمال المرأة، وأمام حبٍّ ظنّه شيطانًا فحاول اجتنابه حتى وقع فريسته، بينما ذاق رمضان نعيم الحبّ الذي قاده إلى نعمة الإمامة بين أناس بسطاء “لا يعذّبهم بكلام عن جهنّم”، لكنّه ضاق قلقًا من زهده بامرأته وبالحبّ، خشية الارتداد إلى الفقر. وعلى الرغم من أنّ القصتين تُفكّكان منظومة يشارك فيها الممسكون بزمام الدين والجمهور معًا، فإنّ شيئًا من الحنوّ والترفّق يتسرّب بين السطور، مذكّرًا القارئ بأنّنا بشر، وأنّ الخطأ جزء من تكويننا.
الرفق نفسه بشخصية تاريخية مظلومة نجده في قصة “مناجاة”. فوحشيّ بقي عالقًا في وضع بينيّ مقلق رافق مسيرته؛ إسلامه مقبول، لكن وجهه مرفوض. هو العبد الذي انتزع حريته بدمٍ أورثه لعنة، إذ أنال من قتلَه المجدَ وبقي هو “مغلولًا بذنب حمزة”. هذه المفارقة الصارخة في مناجاة شخص لم يولد من الأحرار، حيث لم يُؤخذ قتله لمُسيلمة – الذي صُحّح اسمه إلى مَسلَمة – على محمل التصديق، تمثّل مساءلة للعدالة التي تحاصر من لا يملك حرّية الاختيار. ومن خلال مقارنته حاله بحال هند بنت عتبة – آكلة كبد حمزة – التي محا إسلامها ما سلف، يُسمعنا الراوي صوته وهو يهمس: “هي حرّة، وأنا عبد. ولو أنّني، يا رب، من أبناء الأحرار… لترفق بي نبيّك…” منحت القصة وحشيًّا صوتًا واسمًا، بعدما حُرم من حظوة نطق النبي باسمه، بخلاف بلال. كما منحته حرية الانتقاء في موقفه، مستلهمًا قول النبي له: “هل تستطيع أن تغيّب وجهك عنّي؟”؛ فاختار العزلة في البادية بعيدًا من تكفير الناس ومجادلاتهم. رمزية وحشيّ هنا، إلى جانب كونها تجسيدًا لمظلومية العبد المحرَّر الذي بقي أسير لونه وميراثه الاستعبادي وهوانه المقيم، تمثّل أيضًا نبذ الاصطفاف والانقسام والتمذهب منذ زمن التأسيس.
التركيز على هذه القصص الثلاث قد يظلم نصوصًا أخرى مثل “الداخل” بأجوائها السوريالية، وهي تحية محبّة لـ “فجنون” التجربة المصرية الرائدة للفنّان محمد علّام، أو” الفرارجي” بتلميحها السياسي إلى دهاء الحاكم، و”ذاكرة المرايا” المهداة إلى سعد الدين الشاذلي، وأطياف ثلاثية: لو، وعيد، عجوز. جميعها نصوص في محبّة الإنسان والتأمل في الحقّ في الاختلاف؛ فالدنيا، كما الرحمة، تتسع للخلق وتشملهم جميعًا. ومهما اختلفت النصوص، فهي تنويعات على رؤية واضحة تدين الطبقية والعنصرية وعبادة الزعيم واستغلال البسطاء، وتعيد الاعتبار إلى فنّ التوازن في تفكيك المنظومة التي غيّبت معاني المحبة والإيمان، وإلى مبدأ “الرحمة فوق العدل” الأصيل منذ عهود المصريين القدماء.