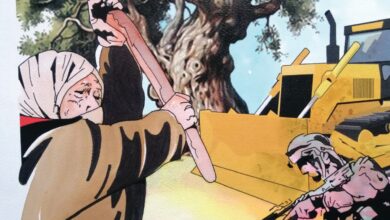تحولات القيم مغربيًّا في ضوء الفكر السوسيولوجي
إنّ الحديث عن التحوّلات القيمية على المستوى المؤسّساتي في المغرب يستدعي العودة إلى المسار التاريخي والأنثروبولوجي الذي عرفه المجتمع المغربي في مجال التضامن والتعاون الاجتماعيّين. فقد شكّلت أشكال التضامن التقليدية القديمة، مثل “الوزيعة” و”التويزة” و”أكادير المخزن”، نماذج حيّة لتجلّيات التكافل الاجتماعي، حيث تجسدت هذه الأشكال في تنظيمات محلية كالجماعة والقبيلة وغيرها. ولم تكن هذه الممارسات مجرّد آليات لتدبير الموارد والجماعات، بل مثلت بنيات اجتماعية وثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم التآزر والانتماء الجماعي، وتجسيد عقل اجتماعي محلي يربط الأفراد بجماعتهم ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وقد أدّت هذه النماذج في أشكالها العرفية دورًا محوريًا في ضمان التنظيم الاجتماعي المشترك، وحلّ النزاعات والصراعات، وتوزيع الموارد بشكل عادل، مما جعلها مرجعًا لثقافة المشاركة واتخاذ القرار الجماعي. ومع دخول المغرب مرحلة التحديث وظهور الدولة الحديثة، برز هذا التحوّل جليًا في الفترة التي وُصِفت بزمن بناء الدولة المغربية الحديثة إبّان نيل الاستقلال سنة 1956، حيث استُلهمت هذه التجارب وأُعيد توظيفها في شكل تنظيمات حديثة، أبرزها الجمعيات.
سعت التنظيمات الجمعوية، على وجه الخصوص، إلى تحويل روح التضامن والتعاون التقليدي إلى إطار قانوني ومؤسّساتي مهيكل يستجيب للرهانات والتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها المغرب. ومن هذا المنطلق، أصبحت الجمعيات تمثّل امتدادًا للديناميات التضامنية التقليدية، لكن في أشكال جديدة متطورة تخضع لإطارات قانونية وتتبنّى أهدافًا واضحة تنطلق من خدمة المجتمع والمصلحة العامة وفق مبدأ “الهدف اللّا ربحي”. فلم تعد الجمعية مجرّد فضاء للتطوّع أو التضامن المحلي، بل تحوّلت إلى فاعل أساسي يضطلع بمهامّ متعددة كانت في السابق من اختصاص الدولة، في مجالات اجتماعية وتعليمية وثقافية ورياضية. وهو ما جعلها تتفاعل مع السياسات العمومية وتكمّل أدوار الدولة، ولا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
غير أنّ العمل الجمعوي في المغرب اليوم يعيش وضعًا مزدوجًا؛ فهو من جهة عنصر فعّال في التنمية الاجتماعية والثقافية ويعكس قدرة المجتمع المدني على المبادرة والانخراط في السياسات العمومية، ومن جهة أخرى يشهد تحوّلات قيمية تطرح تساؤلات حول مدى حفاظه على القيم التقليدية القديمة التي طبعت التنظيمات الاجتماعية السابقة.
إنّ راهن العمل الجمعوي، بوصفه أنموذجًا، يعرف تحوّلات جوهرية على مستوى القيم. فقد أصبح في معظمه قائمًا على رهانات فردية واستراتيجيات عقلانية للفاعلين داخل التنظيم الجمعوي، وهو ما يشكّل انقلابًا على القيم التقليدية للتضامن والتعاون التي قامت عليها تلك التنظيمات الاجتماعية. وتظهر هذه التحوّلات في مظاهر عدة، أبرزها الحضور الكمّي المتزايد للجمعيات، الذي يعكس أهميتها المتنامية في الحقل الاجتماعي، حيث يتزايد عددها سنويًا وتتنوّع مجالات تدخلها بين التعليم والثقافة والرياضة والخدمات الاجتماعية، في مشهد يعكس دورها في سدّ ثغرات كانت الدولة تتكفّل بها سابقًا.
غير أنّ هذا الحضور الكثيف والتطوّر الكمّي جعل التنظيمات الجمعوية تنأى عن القيم الأساسية للتضامن والتعاون وخدمة المصلحة العامة، إذ تحوّل منطق اشتغالها من منطق تضامني–تعاوني إلى منطق مقاولاتي–ربحي، الأمر الذي أضعف دورها الاجتماعي الأصلي. ويمكن تفسير هذه الظاهرة في ضوء مفهوم “التفكيك القيمي” في علم الاجتماع، حيث تتراجع قيم التضامن والتعاون لتحلّ محلّها المصلحة الفردية بوصفها أولوية على حساب المصلحة العامة، خصوصًا في ظلّ إطار قانوني ضعيف يتيح حرية واسعة للفاعلين داخل الجمعيات في تبنّي استراتيجيات شخصية.
ويمكن ربط هذه الملاحظة بالفكر الكلاسيكي لـ “ابن خلدون”، الذي أكّد في “المقدّمة” أنّ استمرار الجماعات رهين بروح التعاون والعصبية الإيجابية بين أعضائها، وأنّ غياب هذه الروح يؤدّي إلى ضعف التنظيم الاجتماعي وتراجع قدرة الجماعة على حماية مصالحها العامة. وقد ذهب ابن خلدون إلى القول: “إنّ الاجتماع الإنساني ضروري، فالإنسان مدني بالطبع، أي لا بدّ له من الاجتماع الذي بمعناه يحيل على العمران البشري”.
ومن هذا المنظور، فإنّ التحوّلات القيمية داخل الجمعيات الحديثة تعكس صراعًا خفيًّا بين الأهداف الفردية والرهانات الشخصية من جهة، والمصلحة العامة والالتزام بقيم التضامن والتعاون التي أرساها التاريخ الاجتماعي المغربي من جهة أخرى.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إنّ التحوّلات القيمية على المستوى المؤسّساتي اليوم ليست مجرّد مسألة فردية، بل هي نتاج تفاعل ديناميكي بين التوجّهات الفردية للفاعلين والسياسات العمومية التي تنتهجها الدولة، حيث تتقاطع الرهانات الفردية مع أهداف المصلحة العامة القائمة على قيم التضامن الاجتماعي.