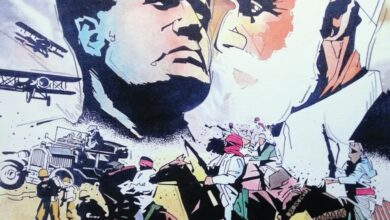موت الانسان عند ميشال فوكو وثورة الذكاء الاصطناعي
نفتتح الحديث بالسؤال: هل هناك روابط بين مفهوم “موت الإنسان” عند ميشال فوكو، والثورة الراهنة في الذكاء الاصطناعي؟
لصياغة إجابة وافية، قد يكون من المناسب أوّلًا تفكيك مفهوم فوكو لـ “موت الإنسان”، ثم ربطه بالظاهرة التي نشهدها اليوم والمتمثلة بثورة الذكاء الاصطناعي.
ولفهم أعمق للفكرة، من المفيد النظر إليها ضمن الإطار الأعم والأعمق لفكر ميشال فوكو، أي ما يُعرف بـ “أركيولوجيا المعرفة”. ففوكو لم يكن معنيًا بالإنسان من حيث هو كائن بيولوجي، بل بالإنسان كموضوع للمعرفة وكذاتٍ للمعرفة في الوقت نفسه. ومن هنا يطرح السؤال: ماذا يعني مفهوم “موت الإنسان” عند هذا الفيلسوف الفرنسي؟
بداية، لا يقصد فوكو بمفهوم “موت الإنسان” الانتفاء الجسدي البيولوجي للإنسان، بل يشير إلى نهاية الإنسان بوصفه مركزًا للمعرفة ومعيارًا لها، وهو المفهوم الذي ترسّخ في الفلسفة الغربية منذ عصر التنوير.
في كتابه “الكلمات والأشياء” (1966)، يذهب فوكو إلى اعتبار الإنسان اختراعًا حديثًا، أو بالأحرى عنصرًا معرفيًا ظهر منذ حوالي مئتي عام مع بروز “علوم الإنسان” مثل البيولوجيا والاقتصاد وفقه اللغة. فالإنسان، وفق هذا المنظور، كان هو الذات المانحة للمعنى، وفي الآن نفسه الموضوع المدروس.
غير أنّ فوكو يرى أنّه قبل أواخر القرن الثامن عشر لم يكن هناك “إنسان” بالمعنى الحديث للكلمة، بل كانت هناك “طبيعة بشرية” تُفهم ضمن نظام كوني أو إلهي أشمل. آنذاك، لم يكن البحث المعرفي منصبًا على الإنسان باعتباره كيانًا مستقلًا، بل على انتظام العالم في كليّته.
مع عصر التنوير وصعود ما يسميه فوكو بـ “السلطة الحيوية (Biopower)”، أي السلطة التي تتحكم بالحياة البشرية من صحة وتكاثر وإحصاءات، بدأ النظر إلى الإنسان بوصفه مشكلة معرفية يجب وضعها على طاولة البحث. وهكذا ظهرت البيولوجيا لدراسة الكينونة الحيوية، والاقتصاد لدراسة حاجات الإنسان وسلوكه الإنتاجي، وفقه اللغة لدراسة لغته ووعيه.
هنا تبرز المفارقة المؤسسة: (The Founding Paradox)فقد أصبح الإنسان هو الذات العارفة، أي العالم والفيلسوف والطبيب، وفي الآن نفسه الموضوع المعلوم، أي الكائن الذي يُحسب ويُصنّف ويُحلّل ويُقيَّم. هذه الازدواجية هي التي أفضت إلى “اختراع” الإنسان كفكرة مركزية.
وعلى هذا الأساس، يعلن فوكو عن “موت الإنسان”، لأن هذا الكائن المزدوج ـــ بين كونه ذاتًا وموضوعًا ـــ ليس إلا ظاهرة عابرة في تاريخ الفكر. وما يُنهيه كمفهوم هو صعود أنماط التفكير البنيوية التي نزعت عنه مركزيته وزحزحته من موقع السيادة المعرفية.
بهذا، فاللغة لا يتكلّمها الإنسان، بل “هي التي تتكلّمه”. فقد أظهر علم اللغة عند فرديناند دي سوسير أنّ اللغة نظام مستقلّ وقَبْلي، وأنّ الفرد لا يصنع معنى الكلمات من نيّته أو ذاتيّته الشخصية، بل يستخدمها في ضوء موقعها داخل البنية اللغوية ذاتها.
وكما أنّ اللاوعي يحدّد الوعي في التحليل النفسي الفرويدي، فإنّ جاك لاكان ذهب أبعد من ذلك حين أكّد أنّ وعينا وإرادتنا ليسا سيِّدي نفسيهما، بل محدّدان بقوى لا واعية لا نسيطر عليها.
وفي السياق ذاته، أظهرت الأنثروبولوجيا عند كلود ليفي- ستروس أنّ البُنى الاجتماعية العميقة ـــ مثل أنساق القرابة ـــ هي التي تنظّم العلاقات الإنسانية، وذلك بمعزل عن وعي الأفراد أنفسهم.
وبالنتيجة، فإنّ الإنسان الذي يتوهّم أنّه ذات حرّة مطلقة وواعية، ليس سوى نتيجة مؤقّتة لشبكة معقّدة من الأنظمة: اللغوية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية. وهذه الأنظمة هي التي تنتج وَهْم “الذات المستقلة”.
وعليه، فإنّ “موت الإنسان” هو موت هذه المركزية الوهمية، وكشفٌ عن حقيقة أنّ الإنسان مجرّد أثر ناتج عن تقاطعات خطابات وقوى أعمق منه. وباختصار، إنّ موت الإنسان يعني تفكيك فكرة أنّه كائن مستقل، عاقل، ذو جوهر ثابت، أو أنّه مصدر لكل معرفة.
***
نأتي الآن إلى التوسّع في المقاربة بين مفهوم “موت الإنسان” عند فوكو، وثورة الذكاء الاصطناعي. ومن المهم الإشارة إلى أنّ الذكاء الاصطناعي ـــ في هذه القراءة ـــ ليس مجرّد أداة تقنية، بل هو التجسيد المادّي والنهائي للأنظمة البنيوية التي تحدّث عنها فوكو، والتي تبدو في يومنا هذا أكثر فعالية ووضوحًا، بل وأكثر قهرًا.
ولعلّه ليس بعيدًا من الواقع اعتبار ثورة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما التوليدي منه مثل ChatGPT وغيره، تمثيلًا حقيقيًا وملموسًا لما يمكن وصفه بنبوءة فوكو. ويتجلّى ذلك في عدّة نقاط:
أولًا: نزع المركزية عن العقل البشري: إذ لم يعد العقل البشري ــ بما يحمله من وعي وعقلانية وإبداع ــ هو السمة الفريدة التي ترفعه إلى مصاف الكائن المحوري للكون.
ثانيًا: الإبداع: حيث أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على كتابة نصوص أدبية وبحثية، وتأليف الموسيقى، وإنتاج الرسم والتصوير بدقّة عالية. ولم يعد الإبداع حكرًا على عبقرية الإنسان.
ثالثًا: العقلانية والتحليل: يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات بكفاءة تتجاوز قدرات الإنسان، واكتشاف أنماط وعلاقات خفيّة، واتّخاذ قرارات عقلانية ــ خصوصًا في ميادين كالطبّ ــ تفوق ما يمكن للبشر إنجازه.
رابعًا: اللغة: لقد كانت اللغة الوسيلة الإنسانية الأسمى للتواصل، لكنّ الذكاء الاصطناعي بات يفهمها ويولّدها ويتلاعب بها وفق أنظمة معقّدة، حتى غدا وكأنّه يجرد اللغة من قدسيتها الإنسانية.
وعليه، فإنّ هذه النقاط مجتمعة تتوافق تمامًا مع أطروحة فوكو حول “موت الإنسان”، إذ لم يعد العقل الفردي مركز التفكير والإبداع والتحكّم، بل أفسح المجال أمام “عقل آخر” يتمثّل في الشبكات العصبية الآلية، العاملة ضمن منظومات ضخمة من البيانات، والقادرة على إعادة تشكيل المعرفة ذاتها.
بهذا، يمكن القول إنّ “الجوهر” الذي يُفترض أنّه يمثّل الإنسان في طريقه إلى التبلور، إن لم نقل إلى الإقصاء. فعلم الإنسان في القرن التاسع عشر اختزل الكائن البشري إلى كائن بيولوجي – اقتصادي – لغوي. أمّا الذكاء الاصطناعي اليوم فيختزل الإنسان إلى مجموعة من الإشارات الرقمية. فالشعور بالحرية، والحب، والخوف، والصحة… إلخ، كلّها باتت قابلة للتمثيل ضمن سلاسل من الأصفار والآحاد يمكن تحليلها إحصائيًا. وهذا، إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على إلغاء أي جوهر متعالٍ أو روحاني للإنسان.
وقد رأى فوكو أنّ الإنسان محكوم بما أسماه “أنظمة الخطاب” (الطبي، والجنائي، والاقتصادي… إلخ) التي تُسهم في تشكيل هويته وسلوكه. غير أنّ ما نعيشه اليوم يكشف أنّ الذكاء الاصطناعي يمثّل نظامًا أقوى من الأنظمة البشرية التقليدية، بل ويسبقها بمراحل. فإذا أردنا التمثيل على ذلك، لوجدنا أنّ الخوارزميات هي التي تشكّل الواقع المعيش للإنسان: فهي التي تحدّد ما يراه على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يشتريه، وما يتعرّف إليه. وهكذا تخلق “حقيقة” للإنسان لا من داخله، بل من خلال برمجيات تحيط به.
وفي الإطار نفسه، تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتصنيف البشر وتحديد احتمالية كون الفرد مجرمًا أو مريضًا أو غير ذلك. ومن ثمّ، فإنّ الهوية الاجتماعية نفسها باتت تُبنى وتُحدَّد عبر الخوارزميات، لا عبر إرادة الإنسان الحرّة وحدها. أمّا المعرفة وإنتاجها، فلم تعد حكرًا على العقل البشري، بل صارت نتاجًا تحقّقه الخوارزميات عبر تحليل كمّيات هائلة من البيانات. وهكذا تحوّلت المعرفة من كونها ثمرة فكر إنساني، إلى نتيجة نظام تقني.
ولعلّ أكثر الروابط إثارة للرهبة أنّ الإنسان الذي كان في عصر التنوير يُنظر إليه باعتباره كائنًا بيولوجيًا عاقلًا، أصبح في عصر الذكاء الاصطناعي مجرّد مجموعة من البيانات. فالحياة، والعلاقات، والمشاعر، والصحة لم تعد إلا بيانات تُغذّى بها الخوارزميات، فيُمحى “الجوهر الإنساني” المجرّد ويُختزل إلى أنماط قابلة للقياس والتحليل والتنبؤ.
وهذا، إن مثّل شيئًا، فإنما يمثّل “موت الإنسان”، بمعنى موت الفكرة المثالية عنه، وتحويله إلى موضوع دراسة لنظام تقني. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ فوكو لا يطرح حكمًا قيميًا بقدر ما يقدّم تشخيصًا تحذيريًا: فـ”موت الإنسان” ليس نهاية العالم، بل هو نهاية صورة محدّدة عن العالم كانت متمركزة حول الإنسان.
ويبقى السؤال: هل يعني ذلك موتًا حرفيًا للإنسان؟
الإجابة عن هذا السؤال قد تستدعي مجلّدات، لكن يمكن الإلماح إلى أنّ “موت الإنسان” عند فوكو لا يعني بالضرورة موتًا واقعيًا أو بيولوجيًا، بل تحوّلًا جذريًا في كيفية فهم البشر لأنفسهم ولمكانهم في العالم.
ومن خلال التجربة المعاشة مع ثورة الذكاء الاصطناعي ـــ والتي لم يمضِ على انطلاقتها سوى سنوات قليلة ـــ نجد أنّها لا تقتل البشر جسديًا، لكنها تقتل، بطريقة ما، الفكرة القائلة إنّ الإنسان هو المسيطر والمتحكّم بكل شيء. بل إنّها تدفعه إلى إعادة طرح التساؤلات الجوهرية التي أثارها فوكو: من نحن؟ ما هي حرّيتنا في عالم تحكمه أنظمة معقّدة؟ ما طبيعة الإبداع والوعي عندما يكون للآلة وجودها ومحاكاتها؟
وفي هذا السياق، يمكن القول، في الختام، إنّ ميشال فوكو قد يبدو وكأنّه نبيّ العصر الرقمي؛ فقد أدرك أنّ القوى البنيوية (التي تتمثّل اليوم في الخوارزميات والبيانات) هي التي ستشكّل مصائرنا، وتفكّك الصورة التقليدية للإنسان بوصفه الكائن الأكثر قوّة وتحكّمًا في العالم. وهذه الرؤية تبدو اليوم أكثر حضورًا ومناسبة من أي وقت مضى.