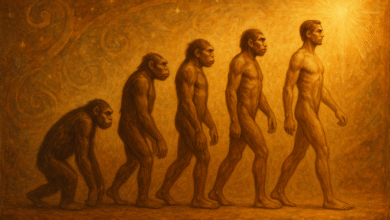هل الشعر يموت؟
يشيع في الأوساط الثقافية الحديث عن تراجع مكانة الشعر، وأنه لم يعد يجذب سوى قلة من القراء، وأن دور النشر أصبحت تتحاشى نشره إلا إذا تحمل الشعراء تكاليف الطباعة بأنفسهم. وبناءً على ذلك، يدفع هذا الواقع المزري العديد من النقاد إلى التساؤل: هل الشعر في طور الاحتضار أم أنه قد مات فعليًا؟
ولكن دعونا نفكك هذه الأزمة إلى عناصرها الرئيسة:
أولًا: عنصر العرض والطلب: هنا نضع الإصبع على الجرح الاقتصادي-الثقافي، حين نرى أن الشعر قد أصبح “سلعة” في سوق لا ترحم، وأن “الطلب” على هذه البضاعة قد تراجع لصالح أشكال ثقافية أخرى أسرع إيقاعًا، مثل الرواية ومنصات التواصل والمواد البصرية. وبما أن دور النشر هي في النهاية مؤسسات تجارية تهدف إلى الربح، فإنها ترفض المخاطرة بنشر ما تراه غير مربح. ونتيجة لذلك، يتحول الشاعر من فنان ينتظر دعوة للنشر إلى “زبون” يدفع ثمن طباعة حلمه. وهذه العلاقة المقلوبة تعد أولى علامات “الاحتضار” التي يتحدث عنها النقاد بلا شك.
ثانيًا: هناك عنصر “القلة القليلة”: بمعنى أن الشعر لم يعد ذلك الفن الجماهيري الذي يحفظه الناس ويترنمون به في المجالس، فقد تقلصت دائرة جمهوره إلى فئة محدودة من نقاد وأدباء ومهتمين متخصصين. وهذه “النخبوية” سلاح ذو حدين: حد إيجابي، يتجلى في كون الشعر قد حافظ على طهره ولم يسقط في التبسيط والحسابات التجارية لإرضاء الجميع؛ وحد سلبي، يتمثل في أن الشعر فقد وظيفته الاجتماعية والتأثيرية، وأصبح حوارًا يدور داخل برج عاجي، مما جعله يقطع صلته بمصدر قوته الأساسي، وهو المجتمع والناس.
ثالثًا: ربما نحن أمام السؤال الخطأ: ألا يتعلق الأمر بالتحول وليس بالاحتضار؟ هنا يكمن كنه الموضوع كله. صحيح أن فكرة “موت الشعر” دراماتيكية وجذابة، لكنها ليست دقيقة، لأن الأصح أن الشعر يمر بمرحلة تحول جذري، مثل كل شيء في عصرنا الحالي. وفي هذه الحالة، لماذا لا نتحدث عن موت الأنموذج التقليدي بدل موت الفن نفسه؟ وأقصد بالأنموذج التقليدي: ديوان ورقي يُنشر في دار نشر ويقرؤه قارئ في مكتبة ما أو في بيته.
يمكن القول بأن الشعر وجد بالفعل قنوات جديدة وحيوية، وإن كانت مختلفة عن الأنموذج التقليدي، ومن هذه القنوات نذكر على سبيل المثال:
- منصات التواصل الاجتماعي: أصبح “إنستغرام” و”إيكس (تويتر)” أكبر ساحات شعرية في التاريخ، فقصيدة واحدة يمكن أن تصل إلى ملايين القراء في ساعات، وهو ما لم يحدث أبدًا في عصر المطبوعات.
- الإنشاءات الرقمية: حيث ظهر ما يسمى بـ “الشعر الرقمي”، الذي يدمج النص بالصورة والصوت والحركة.
- أمسيات “سلام”: حيث يعود الشعر إلى جذوره الشفاهية والجماهيرية، ويصبح أداءً حيًا يتفاعل معه الجمهور مباشرة.
كما أن الأمر يتعلق بمشكلة الذوق لا بمشكلة الشعر نفسه، فالعصر الحالي هو عصر “الاستهلاك السريع”، والشعر في جوهره يتطلب تروّيًا وتأملًا من القارئ. وهنا يفرض السؤال نفسه: هل ما نزال نمتلك فسحة من الصفاء الذهني لاستقبال الشعر، أم أننا أصبحنا نفضل الوجبة السريعة ثقافيًا على المائدة الفنية الدسمة؟
الخلاصة أن ما ذكر أعلاه صحيح في تشخيصه لأعراض المرض، لكنه مبالغ في تشخيص نهايته. الشعر لا يموت لأنه يعبر عن أعمق ما في الروح البشرية من مشاعر وأسئلة وجودية. كل ما هنالك هو أن وسائطه وأشكاله وتجارته تتغير.
الشعر الحقيقي لن يموت أبدًا، بل سيبحث دائمًا عن قنوات جديدة ليعبر من خلالها. المشكلة، إذًا، ليست في موت الشعر، بل في عجز آليات النشر والتلقي التقليدية عن مجاراة روح العصر، وفي انشغالنا كبشر عن التوقف لحظة للاستماع إلى نبض اللغة الجميلة.
الموت هو مصير ما لم يعد مفيدًا أو فاقدًا للمعنى، والطبيعة البشرية لن تتخلى أبدًا عن الفن الذي يمنح الوجود بهجة ومعنى. الشعراء الحقيقيون لن يتوقفوا عن الكتابة، وسيظل هناك دائمًا ذلك القارئ الوحيد الذي تلمع عيناه عندما يعثر على قصيدة تعبر عنه؛ وهذه هي المعجزة التي تمنع الموت.
وزيادة على ذلك، الشعر تعبير عن الروح الإنسانية، والروح لا تموت بسهولة. فقد يمرض الشعر ويضعف، ويختفي من الواجهة أو ينحسر أمام ضجيج العالم، لكنه يعود دائمًا في اللحظات التي نحتاج فيها إلى أن نكون بشرًا على حقيقتنا، متأملين ومتسائلين، باحثين عن الجمال والمعنى.
ثم إن عدنا قليلًا إلى بدايات الشعر، وجدنا أنه وُلد مع الإنسان الأول، لا كديوانٍ مُجلّد، بل كنبضٍ حيّ. فقد كان تعبيرًا عن خوفه الممزوج بالدهشة وهو يواجه الكون بليله المظلم وبرقه وصاعقته وغموض الحيوان الذي عليه اصطياده.
كانت الإيقاعات الأولى خطواته على الأرض، ودقاته على الحجر، وأنفاسه المتسارعة. ومن هذه الإيقاعات وُلدت الكلمات الموزونة كتعويذات سحرية لاسترضاء القوى غير المرئية، أو كترانيم احتفالية لاستدعاء الصيد الوفير. كان الشعر، إذًا، لغةً طقوسية جعلت العالم المخيف مكانًا يمكن فهمه، ولو قليلًا.
ومع تقدم الحضارات، ارتقى الشعر في العصور الكلاسيكية من التعويذة إلى السجل التاريخي والشريعة الأخلاقية. كان “هوميروس” يروي ملاحم الأبطال ليخلّد ذكراهم، كما كان الشعراء في الصين القديمة، وبلاد فارس، والهند حراسًا للذاكرة الجماعية وصانعي مجد الأمم. فالشعر آنذاك كان الوسيط الذي يحمل حكمة الشعب وفلسفته المختزلة في أبيات سهلة الحفظ، وكان أيضًا الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تتجاوز الزمن والحدود.
وفي الصحراء العربية، غدا الشعر بطاقة هوية وديوان العرب، يحفظ أنسابهم، ويصف أخلاقهم، ويخلّد معاركهم، ويُغري بالحب والغزل. كانت القصيدة أعلى سلطة أدبية وأخلاقية، والشاعر لسان القبيلة وسلاحها الفتّاك. لم يكن الشعر ترفًا، بل ضرورة وجودية للبقاء والتفوّق الثقافي.
ومع تحوّل العالم، تحوّل الشعر أيضًا؛ فلم يعد فقط سجلّ المجتمعات، بل أصبح مرآة الروح الفردية في العصور اللاحقة. انغمس في الذات الإنسانية، في شكوكها وعذاباتها وأسئلتها الوجودية وأحلامها الصغيرة. صار الصديق الذي نبوح له بأسرارنا، ونضع على كاهله ثقل همومنا.
واليوم، حين يُقال إن الشعر “مات” لأن قيمته السوقية انخفضت، فذلك تبسيط خادع. الحقيقة، كما سبقت الإشارة، أن الشعر لم يمت، بل فرّ من دور النشر ليستوطن حيث يكون الناس: على منصات التواصل الاجتماعي. وهكذا عاد ليتخفّى في ثوب جديد، مستعيدًا مهمته الأولى: أن يكون مباشرًا، آنيًا، شعبيًا. لقد عاد ليكون همسةً بين إنسانين، ولو عبر شاشة.
وطالما بقي فينا نفس بشري، سنحتاج إلى الشعر. وعندما يلمس أخر إنسان على الأرض زهرة متبقية، سينطق حتمًا باستعارة، أو يصنع من خوفه وأمله قصيدة يودعها بين يدي النجوم المحتضرة. فالشعر هو شاهد الوجود الإنساني، وهو الطريقة التي نقول بها: “لقد كنت هنا. هنا أحببت، وتألمت، وطرحت أسئلة”. إنه الندبة والوسام على جسد تجربتنا في الحياة، ولهذا لا يستطيع أن يموت مستقبلًا. نعم، قد يغفو أحيانًا، لكنه سيستيقظ دائمًا عندما يهمس إنسان في أذن آخر: “استمع، لدي ما لا أستطيع قوله إلا بهذه الطريقة”.